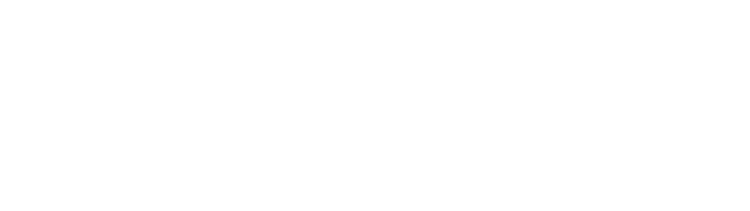في خضم المآسي التي نعيشها والمشاهد التي تُباد فيها الشعوب وتُهجر أمام مرأى ومسمع العالم، يبرز سؤال مؤرق يهز ضمير كل إنسان: عندما يكون الشعب أعزل، مجردًا من أي وسيلة للدفاع عن نفسه، فمن هو حاميه الحقيقي؟
الحقيقة القاسية التي غالبًا ما نحاول التغافل عنها هي أن الشعب الأعزل، عندما يُستهدف، لا يجد من يدافع عنه أو يحميه. والأسوأ من ذلك أن مأساته لا تتعدى كونها مشهدًا عابرًا ومحتوى رقميًا من مقاطع وصور تنتقل بين هواتفنا. نرى هذه المشاهد فنتألم ونغضب ونكتب المنشورات والكلمات القوية، لكنها في النهاية تبقى ضجة مؤقتة تفتقر إلى القدرة الحقيقية على إيقاف المعتدي أو حماية المنكوبين.
قد يتوهم المرء أن الأمان له مصدران رئيسيان: الأمل الذي يتعلق به كل مستضعف في جيش بلاده، الذي يُفترض أن يكون درع الأمة وسيفها، أو المنظمات الدولية وقوات حفظ السلام، التي أُنشئت نظريًا لمنع هذه الكوارث. لكن التاريخ والواقع يثبتان لنا مرارًا وتكرارًا، وبشكل دامٍ، أن جيش الوطن لا يحمي الشعب الأعزل، ولا تنقذه قوات حفظ السلام الدولية. هذه هي الحقيقة الصادمة التي يجب مواجهتها بكل قسوتها.
لماذا يحدث هذا؟ ولماذا تعجز الجيوش عن القيام بأبسط واجباتها؟ الجواب، رغم مرارته، بسيط ومباشر: لأن هذه الجيوش، مهما بلغت قوتها وضخامتها، لا تتحرك بقرار ذاتي. إنها مجرد أداة في يد السياسي، يوجهها ويوقفها متى شاء. فقرار الجيش لا يرتبط بصراخ الأطفال أو استغاثات المنكوبين، بل هو مرهون بحسابات سياسية معقدة، ومصالح اقتصادية، وتوازنات إقليمية ودولية. لذلك، رأينا وما زلنا نرى جيوشًا ضخمة وقدرات هائلة من السلاح موقوفة في ثكناتها، تشاهد عن بعد وهي مكتوفة الأيدي، بينما يُترك شعبها لمصيره تحت النار.
أما الأمل الثاني الذي يعلّقه الناس على العالم الخارجي والمنظمات الدولية، فالواقع فيه أشد قسوة. فهذه المنظمات، إن تحركت أصلاً، تتحرك ببطء يقتل أي فعالية، وتجر وراءها بيروقراطية خانقة وإجراءات معقدة تُشل أي استجابة حقيقية. علاوة على ذلك، قراراتها مقيدة بموافقة الدول الكبرى ومصالحها المتضاربة وبحق الفيتو الذي يجمد نصف العالم لرغبة دولة واحدة. وغالبًا لا تصل فرقها الميدانية إلا بعد انتهاء المجازر وهدوء الدخان، لا لمنع الجريمة، بل لكتابة التقارير وإحصاء الضحايا والإعلان عن تحقيقات قد تستمر سنوات دون أن تُحدث تغييرًا في الواقع. بمعنى آخر، حضورها هو توثيق للمأساة وليس حماية منها.
لكن، هل هذا هو المصير الحتمي الوحيد؟ هل قُدّر على الشعوب أن تكون إما ضحية تنتظر ذبحها أو متفرجًا ينتظر دوره؟ لا، هناك نموذج آخر مختلف تمامًا؛ نموذج الشعوب التي أدركت هذه الحقيقة المرة وقررت أن تتولى هي مسؤولية حماية نفسها. إنها شعوب أيقنت أن القدرة على الدفاع عن الذات ليست خيارًا ثانويًا، بل شرطًا أساسيًا للاستمرار والبقاء.
لنأخذ مثالًا من واقعنا اليوم، قد يبدو مفاجئًا للبعض: في الولايات المتحدة الأمريكية، يتجاوز عدد الأسلحة التي يمتلكها المدنيون عدد سكان البلاد بأسرهم. نعم، هناك أكثر من 393 مليون قطعة سلاح في أيدي الشعب. سبحان الله، هذا رقم هائل بكل معنى الكلمة، ويعني أن هناك أكثر من سلاح لكل رجل وامرأة وطفل؛ إنه مجتمع مسلح حتى النخاع.
قد يظن البعض أن هذا الأمر لا يتجاوز كونه هواية خطيرة أو عادة اجتماعية غريبة، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. فلديهم، امتلاك السلاح ليس رفاهية، بل جزء أساسي من عقيدتهم في الحرية، وهو خط الدفاع الأول والأخير عن حقوقهم وحرياتهم ضد أي تهديد، سواء كان من عدو خارجي أو من حكومتهم نفسها إذا فكرت يومًا في الاستبداد بهم. الفكرة الجوهرية التي ينطلقون منها بسيطة وعميقة ومؤثرة في آن واحد: لا يمكن الحديث عن دولة حقيقية أو حرية حقيقية في وقت يكون فيه الشعب أعزل يعتمد كليًا على الدولة لحمايته، وخاصة من بطش الدولة نفسها. فمن يضمن ألا تنقلب الدولة على شعبها؟ التاريخ مليء بقصص حكومات تحولت إلى جلادين لشعوبها. ولهذا يُعد الحق في حمل السلاح حقًا مقدسًا في دستورهم، لأنه ليس مجرد نص قانوني على ورق، بل هو الضمانة المادية الملموسة والفعالة ضد أي محاولة للاستبداد. هم لا يثقون في الوعود السياسية أو النصوص الدستورية، بل يثقون في قدرتهم الفعلية على حماية أنفسهم. ولذلك، وعلى الرغم من الحوادث المأساوية التي تقع هناك، فإن أي محاولة لنزع السلاح من أيدي الشعب تُقابل بمقاومة شعبية جارفة.
الأمر المدهش حقًا هو أن هذا المفهوم، مفهوم الشعب المسلح المسؤول عن حماية نفسه، ليس مفهومًا غربيًا أو دخيلاً علينا. بل إن أصله وجذوره موجودة في تاريخنا التأسيسي، في النموذج الأول لأمتنا: دولة النبوة في المدينة المنورة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لم يكن هناك ما يسمى جيشًا بالمعنى الحديث. لم تكن هناك ثكنات عسكرية معزولة يعيش فيها جنود كطبقة مستقلة. بل كان المجتمع كله، الأمة بأكملها، هو الجيش. كل فرد مسلم كان مواطنًا وجنديًا في آن واحد، وجزءًا لا يتجزأ من منظومة الدفاع عن الأرض والقيم والعقيدة.
كيف كان هذا ممكنًا؟ تخيلوا المشهد: كان كل صحابي يحتفظ بسلاحه ودرعه في بيته، لا في مخازن حكومية أو تحت تصاريح معقدة. كان سيفه ينام بجانبه، حاضرًا في كل لحظة، كجزء طبيعي من أثاث البيت ومسؤولياته اليومية. لم يكن الصحابي ينتظر قرارًا أو إذنًا سياسيًا من الدولة ليحصل على سلاحه وقت الخطر. وعندما كانت ترتفع صرخة الفزع في أطراف المدينة، كان الرد يحدث خلال دقائق معدودة. لماذا؟ لأن كل رجل كان جاهزًا، وكل بيت كان فيه مقاتل، وكل مقاتل يملك سلاحه. لم تكن المنظومة الأمنية محصورة في سلطة مركزية أو جيش منعزل، بل كانت مسؤولية فردية وجماعية في آن واحد. لم يكن السلاح رمزًا للعنف، بل رمزًا للواجب، للحماية، وللدفاع عن الأرض والعرض والدين، وجزءًا ثابتًا من الحياة اليومية للمجتمع كله.
ماذا كانت نتيجة هذه الروح، روح المسؤولية المشتركة والاستعداد الدائم؟ لقد صنعت مجتمعًا منيعًا وقويًا لا يُهزم بسهولة. لماذا؟ لأن الدفاع لم يكن وظيفة فئة محددة، بل واجب الأمة كلها. كان كل فرد حارسًا، وكل بيت بمثابة قلعة صغيرة. وخلاصة هذا النموذج النبوي العظيم واضحة: المسلمون الأوائل لم يجلسوا ينتظرون جيش الدولة ليأتي ويدافع عنهم. لم يوكلوا مهمة الدفاع عن دينهم وأعراضهم وأرضهم لأحد، بل هم أنفسهم كانوا الجيش، وهم خط الدفاع الأول والأخير.
هذا الدرس العميق الذي تعلمناه من تاريخنا يتكرر اليوم أمام أعيننا في واقعنا المعاصر. فالتاريخ لا يمل من إعادة دروسه، لكن المشكلة في الذين لا يقرؤون أو يقرؤون ولا يتعلمون. لنقارن اليوم بين حالتين واضحتين: حالة الأمم العُزّل التي يُقرر مصيرها دائمًا في عواصم أخرى، وتبقى تحت رحمة القوى الكبرى ومصالحها. وعند تعرضها لهجوم، تتحول ببساطة إلى قصة إعلامية ومقاطع فيديو تنتقل من جهاز لآخر. وفي المقابل، حالة الأمم التي تمتلك القدرة على حماية نفسها؛ فمجرد امتلاكها لهذه القوة يجعل تكلفة الاعتداء عليها باهظة جدًا. وهذا يخلق قوة ردع حقيقية تفرض احترامها على الجميع وتجعل صوتها مسموعًا في المحافل الدولية.
الحقيقة القاسية التي يجب أن ندركها جميعًا هي أن الأمم لا تُصان بالشعارات الحماسية، ولا بالوعود السياسية، ولا بالاتفاقيات الدولية الهشة التي تتمزق عند عبور أول دبابة للحدود. فالشعب الذي لا يملك القدرة المادية على الدفاع عن نفسه سيبقى دائمًا لعبة في أيدي الآخرين، ينتظر قرارهم إما بالنجاة أو الهلاك. وقد لخّص أحد حكماء التاريخ هذا المعنى بكلمات حادة: “ليس الحر من ينتظر أن تأتيه الحماية من الخارج، بل الحر هو من يحمل القدرة على توفير هذه الحماية بنفسه”. فالحرية التي تحتاج حماية من غيرك ليست حرية، بل عبودية مؤجلة. الحرية والقدرة وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان.
هذه هي الحقيقة التي فهمها الصحابي الجليل بفطرته وإيمانه قبل 14 قرنًا، وفهمها الأمريكي المعاصر بواقعيته ومصلحته. وهي للأسف الحقيقة ذاتها التي غابت عن وعي الكثير من شعوبنا بعد أن سُلبوا هذا الحق والمسؤولية، وأُقنعوا بأنه ليس عليهم سوى انتظار الحماية من غيرهم.
في الختام، يجب أن ندرك ما هي المأساة الحقيقية. فالمأساة ليست في الهزيمة فقط، فالتاريخ مليء بالانتصارات والهزائم. لكن المأساة التي تفوق كل مأساة هي أن يسقط شعب وهو لا يملك حق المقاومة، لا يملك حق الدفاع عن وجوده. تتجسد المأساة في ذلك المشهد الموجع الذي يتكرر كل يوم: بيت يُقتحم، وأب يُقتل على عتبة داره أمام أعين أهله، وهو ينظر إليهم بنظرة العجز الأخيرة. وهكذا يصرخ الواقع في وجوهنا: الشعب الذي لا يملك القدرة على حماية نفسه سيبقى ينتظر مصيره ولن يصنعه أبدًا. وربما أخطر سؤال يواجهنا اليوم ليس “من سيحمينا؟”، بل السؤال الذي يجب أن نسأله بصدق مؤلم: “هل تركنا أنفسنا، بإرادتنا أو رغماً عنا، بلا أي وسيلة للحماية أصلاً؟”