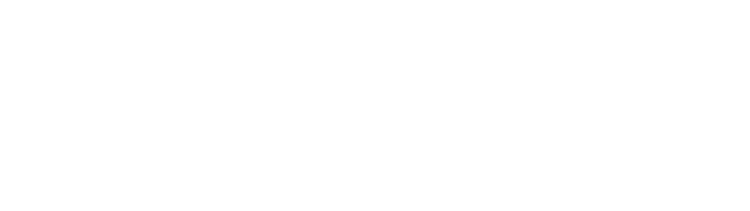في خضم هذا العالم المتلاطم بالأفكار، وحيث أصبحت الشاشات الصغيرة نوافذنا على فضاءات لا حدود لها من المعلومات والشبهات، يبرز سؤال كبير يطرق أبواب مجتمعاتنا بقلق متزايد: لماذا يتجه بعض شبابنا نحو الإلحاد؟
هذا السؤال ليس مجرد تساؤل فكري عابر، بل هو صرخة تكشف عن وجود فراغ ما، أو ألم ما، أو حيرة ما في نفوس هؤلاء الشباب.
إن التعامل مع هذه الظاهرة بمنطق التجاهل هو بمثابة ترك جرح مفتوح دون تطهير أو علاج.
فالإلحاد عرض خطير لأسقام فكرية ونفسية وروحية تراكمت بمرور الوقت.
لذا، فإن مهمتنا التشخيص الدقيق والفهم العميق، تمامًا كما يفعل الطبيب الحاذق الذي يبحث عن جذور العلة ليصف الدواء الناجع.
والآن نبدأ مع ذكر أبرز وأهم الأسباب والحلول:
السبب الأول: ضعفُ التحصينِ العلمي والشرعي
السبب الأول: ضعفُ التحصينِ العلمي والشّرعيِ، فإذا صاحَبَ ذلك فضولٌ قاتل، وجُرأةٌ على الخوض في أمورٍ أكبرَ من طاقة العقلِ الغيرِ محصَّن، فربما أوقعَ الإنسانُ نفسه في التيه والضلالِ. ولا نقولُ إنَّ الخوضَ في هذه الأمورِ ممنوعٌ مُطلقًا، بل نقولُ إنهُ لا بدَّ قبل ذلك من حصانةٍ واستعدادٍ عِلميٍ قويٍّ، وعلى يدِ شخصٍ خبير، كمن يريدُ أن يغوصَ في أعماق البحار، فلا بدَّ أن يتجهزَ بأجهزةٍ خاصة، ولا بدَّ أن يتدرّبَ جيدًا، وأن يتدرّجَ في ذلك تحت إشرافِ مُدربٍ خبير، وإلا فما أسهلَ أن يغرقَ ويهلك.
والحل ليس أن نمنعك أيها الشاب من السباحة، بل أن نُعِدّك لتكون “غواصًا ماهرًا”. وهذا الإعداد يقوم على ركيزتين أساسيتين لا تنفصلان:
الركيزة الأولى: تجهيز “القلب” قبل “العقل” (أنبوبة الأكسجين).
قبل أن تغوص في بحر الشبهات، يجب أن يكون لديك مخزون أكسجين روحي يجعلك صامدًا. هذا الأكسجين هو صلتك بالله.
لماذا؟ لأن كثيرًا من الشبهات لا تُهزم بالعقل وحده، بل بنور القلب وطمأنينته. عندما يكون قلبك عامرًا بحب الله، ومعرفته من خلال أسمائه وصفاته، وتشعر بلذة مناجاته في صلاتك، فإن هذا الإيمان يصبح بمثابة “بوصلة داخلية”.
إذا ضل عقلك الطريق للحظات، فإن بوصلة قلبك ستبقى دائمًا متجهة نحوه سبحانه.
كيف؟ هذا ليس كلامًا نظريًا. خصص وقتًا للقرآن “تدبرًا” لا مجرد قراءة. ادرس أسماء الله الحسنى لتعرف من تعبد. حافظ على أذكارك، فهي درع يحمي القلب من الوساوس. هذا هو الأكسجين الذي سيجعلك تتنفس تحت الماء بينما عقلك يعمل.
الركيزة الثانية: تجهيز “العقل” بالأدوات الصحيحة (خريطة الغوص والتدريب).
الإسلام دين العقل والبرهان. وهو يمنحك منهجية علمية صارمة للتعامل مع الأفكار، وهي تقوم على مبدأين:
التأسيس قبل الخوض (Learn to walk before you run): لا يمكن لطالب في الابتدائية أن يفهم أبحاث الفيزياء النووية. وبالمثل، لا يمكن الخوض في أعقد الشبهات الفلسفية حول “مشكلة الشر” أو “السبب الأول” دون أن تتسلح أولًا بـ:
أصول العقيدة الإسلامية: ما هي أدلة وجود الله العقلية والفطرية؟ ما هي براهين النبوة؟ ما هي حقيقة الوحي؟ هذه هي الأساسات التي تبني عليها كل شيء.
تعلم كيف تكتشف المغالطات المنطقية في كلام الملحدين. كثير من شبهاتهم مبنية على مغالطات براقة لكنها فارغة عند التحليل.
الاستعانة بأهل الخبرة (الغوص مع المدرب الخبير): يقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. هذه ليست دعوة للتقليد الأعمى، بل هي أرقى درجات المنهجية العلمية: “الرجوع للمتخصص”.
عندما تمرض، تذهب للطبيب. وعندما تريد بناء منزل، تستشير مهندسًا. فلماذا عندما يتعلق الأمر بأخطر قضية في وجودك (دينك ومصيرك)، تظن أنك تستطيع خوضها بمفردك وتستمع فقط لمن يريد هدم بنائك؟
الخلاصة: يا صديقي الشاب، فضولك كنز، وشجاعتك في البحث عن الحقيقة محل تقدير. لكن حوّل هذا الفضول من “فضول قاتل” إلى “فضول بنّاء ومُنَهَّج”.
لا تقفز في البحر الهائج، بل تعلم السباحة أولًا على الشاطئ. ابْنِ علاقتك بربك ليكون معك الأكسجين، وتعلّم أصول دينك لتكون معك الخريطة، واستعن بالعلماء الموثوقين ليكونوا لك خير مُدرب. حينها فقط، ستتحول رحلة البحث عن اليقين من مغامرة محفوفة بالهلاك، إلى رحلة ممتعة وآمنة تكتشف فيها جواهر الإيمان ولآلئ الحقيقة.
السببُ الثاني: ميلُ البعضِ نحو الانفلاتِ من القيود الدّينية
السببُ الثاني: ميلُ البعضِ نحو الانفلاتِ من القيود الدّينية، والاستعدادِ لأن يُضحيَ عمدًا بتدينه؛ ليتمكنَ من تلبية شهواتهِ المحرمةِ بلا أيّ قيودٍ أو تأنيبِ نفس؛ وذلك يعني أن يقتُلَ الإنسانُ ضميرهُ ونفسهُ الّلوامة؛ حتى لا يبقى في نفسه من يُنازعهُ في المعصية. ويظنُّ أنه بذلك صار حُرًّا، وهو في الحقيقة قد وقعَ عبدًا لشهواته، وأسيرًا لأهوائه، فتحول من عبادة الله إلى عبادة نفسه وهواه وشهواته، وكما قال أحدهم بصدق:
“أردتُ أن أعيشَ بلا ربّ، لا لأنني اقتنعتُ بعدم وجوده، بل لأنني أردتُ ألا يحاسبني أحد”.
هذا الاعتراف: “أردت أن أعيش بلا رب لأني لا أريد أن يحاسبني أحد” هو من أصدق ما قيل في وصف هذه الحالة.
إنه لا يدّعي قناعة عقلية، بل يكشف عن رغبة نفسية عميقة. وهنا، لا بد أن نتوقف لنسأل: ما هي “الحرية” التي يبحث عنها هذا الشاب؟ وهل وجدها حقًا في الإلحاد؟
دعنا نتأمل في هذا المفهوم الذي يبدو براقًا: “الانفلات من القيود الدينية”.
الحرية الحقيقية.. أم العبودية الجديدة؟
يظن الشاب أنه بقتل “النفس اللوامة” وبإسكات صوت الضمير، قد تحرر. ولكن ما حدث في الحقيقة هو أنه لم يتحرر، بل قام فقط بـ “استبدال سيّدٍ بسيّد آخر”. لقد فرّ من عبودية الله الرحمن الرحيم، الذي كرمه ونفخ فيه من روحه، ليقع في عبودية أهوائه وشهواته المتقلبة، التي لا تشبع ولا ترحم.
لنرسم الصورة بوضوح: في ظل عبودية الله: أنت عبدٌ لربٍ واحد، كامل، عليم، حكيم. أوامره ونواهيه ليست قيودًا للانتقاص منك، بل هي كـ “كتالوج المصنِّع” الذي يعرف أسرار صنعته وكيف تعمل بأفضل كفاءة. هي حدود تحميك من تدمير نفسك، تمامًا كعلامات التحذير على الطريق التي تمنعك من السقوط في الهاوية. هذه العبودية تمنحك كرامة وقيمة وهدفًا.
في ظل عبودية الهوى: أنت عبدٌ لآلاف الأسياد المتقلبين: شهوتك اليوم، مزاجك غدًا، ضغط أصحابك، الموضة، إغراءات الإعلام، القلق من فوات المتعة… كل هذه أسياد لا ترحم، تطلب منك المزيد والمزيد. كلما أطعتها، زادت طلباتها، وكلما أشبعت رغبة، ولدت رغبة أكبر وأشد. أنت تركض في حلقة مفرغة من اللذة اللحظية التي يتبعها فراغ هائل.
إذن، فالشاب لم يتحرر، بل انتقل من عبودية منظّمة وهادفة ترفع من شأنه، إلى عبودية فوضوية مُهينة تستنزف روحه وجسده.
قتل الضمير: هل يجلب السعادة أم يفتح أبواب الجحيم؟
يعتقد البعض أن “تأنيب الضمير” هو عدو السعادة. ولكن في الحقيقة، النفس اللوامة التي أقسم الله بها في القرآن، هي جهاز إنذار إلهي مزروع في فطرتك. هي ليست عدوك، بل هي صوت الحقيقة بداخلك، هي بوصلتك الأخلاقية التي تحاول إعادتك إلى الطريق الصحيح كلما انحرفت.
تخيل أنك تقود سيارة، وأضاءت لمبة التحذير الخاصة بزيت المحرك. هل الحل هو أن تحطم هذه اللمبة المزعجة لتكمل طريقك “بحرية”؟
بالطبع لا! هذا هو قمة الحُمق. تحطيم اللمبة لن يحل المشكلة، بل سيجعلك تتجاهلها حتى يحترق المحرك وتتدمر السيارة بالكامل.
هذا بالضبط ما يفعله من يقتل ضميره. هو لا يتخلص من الألم، بل يتخلص من “جهاز الإحساس بالألم”. والنتيجة هي أنه يغوص أعمق في وحل تدمير الذات، روحيًا ونفسيًا وجسديًا، دون أن يشعر، حتى يجد نفسه في النهاية حطامًا فارغًا يتساءل: “أين السعادة التي كنت أبحث عنها؟”.
ما يبحث عنه هذا الشاب ليس “السعادة الحقيقية”، بل هو “اللذة اللحظية”. والإسلام لا يحارب اللذة، بل يهذبها ويضعها في إطارها الصحيح الذي يحقق للإنسان سعادة أعمق وأبقى، وهي “السكينة والطمأنينة”.
اللذة: عابرة، سطحية، تحتاج إلى جرعات متزايدة، وتترك بعدها فراغًا. هي متعة الجسد.
السكينة: دائمة، عميقة، تملأ القلب رضا وطمأنينة، حتى في أصعب الظروف. هي متعة الروح.
إن مطاردة الشهوات المحرمة بلا قيود كمن يشرب من ماء البحر، كلما شرب منه ازداد عطشًا. أما الطاعة والالتزام بمنهج الله، فهي كالشرب من نبع الماء العذب، يروي ظمأ الروح ويمنحها الحياة.
الخلاصة: يا صديقي الباحث عن الحرية، دعوتك صادقة، لكن وجهتك خاطئة. الحرية الحقيقية ليست في أن تفعل ما “تريد”، بل في أن تتحرر مما “يستعبدك”.
الإسلام لم يأتِ ليسجنك، بل جاء ليحررك من سجن أهوائك، ومن فوضى رغباتك، ومن ضغط مجتمع لا يرحم. جاء ليمنحك الحرية الأسمى: أن تكون عبدًا لله وحده، وبالتالي، حرًا من كل شيء سواه.
فأعد النظر في تعريفك للحرية، واسأل نفسك بصدق: هل هذا الانفلات منحني سلامًا داخليًا وسكينة، أم أدخلني في دوامة لا تنتهي من القلق والفراغ والركض خلف سراب؟
السببُ الثالث: الانفتاحُ على كُتب الفلاسفةِ والملحدين
السببُ الثالث: الانفتاحُ على كُتب الفلاسفةِ والملحدين المليئةِ بالشبه المبهرجةِ، والعِباراتِ المنمّقةِ، مما يجعلُها تنطلي على ضعفاء الإيمان، ومحدودي الثّقافةِ الشّرعية، لأن الاطلاع عليها بدون حصانةٍ فكريةٍ قويةٍ سيسببُ (تأثيراتٍ سلبيةً) يصعبُ علاجهُا، والتخلصَ من آثارها.
ولحل هذا الإشكال يجب أن نؤكد أن الكلمة لها سحرها، والأسلوب الجذاب قد يُغلف أبشع الأفكار فيبدو جميلًا.
كثير من كتابات الملاحدة والفلاسفة المشككين لا تعتمد على قوة الحجة بقدر ما تعتمد على قوة “البيان” و”العرض”.
هي أشبه بساحر ماهر يبهرك بحركاته السريعة ويده الخفيفة، فتُصدّق أن المستحيل قد حدث، بينما الحقيقة أنه استخدم خفة اليد وخداع البصر ليصرف انتباهك عن الحقيقة.
دعنا نكشف سر هذا الساحر، ونرى كيف تعمل هذه “الشبهات المبهرجة”.
كيف يعمل السحر؟ كشف أسرار الأسلوب الجذاب
هذه الكتابات غالبًا ما تستخدم ثلاث حيل أساسية لتمرير أفكارها إلى العقل غير المحصّن:
خلط الحق بالباطل: هي لا تقدم لك باطلًا صرفًا، فهذا يسهل كشفه. بل تأخذ جزءًا من الحقيقة (مثلاً: وجود الألم في العالم)، ثم تبني عليه استنتاجًا باطلًا (إذن، لا يوجد إله رحيم). إنها تعطيك مقدمة صحيحة لتجعلك تبتلع النتيجة الفاسدة التي تليها.
اللعب على وتر العاطفة: تستخدم لغة عاطفية قوية ومؤثرة، وتصور نفسها في موقع “البطل المتمرد” الذي يدافع عن العقل ضد الخرافة. هذا يخاطب غريزة التمرد لدى الشباب ورغبتهم في الظهور بمظهر المفكر الحر والمستقل، فتتحول القناعة من مسألة “برهان” إلى مسألة “هوية” و”شعور بالتميز”.
بناء القصور على أساسات وهمية: تبدأ من مُسلَّمات وفرضيات غير مُثبتة ثم تبني فوقها صرحًا منطقيًا يبدو متماسكًا.
لكن إذا هززت الأساس، انهار القصر كله. المشكلة أن القارئ غير المحصن ينبهر بجمال القصر، ولا يفكر أبدًا في تفقد أساساته.
والإسلام لا يخشى الأفكار، ولا يأمرنا بدفن رؤوسنا في الرمال. بل على العكس، القرآن مليء بالتحديات العقلية للمخالفين: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾. “أعطني دليلك وبرهانك”. هذه عقلية من يثق بما لديه، لا من يخشى ما لدى الآخرين.
إذن، الحل ليس “المنع” و “التحريم” من القراءة، بل هو “التسليح” و “التحصين” قبلها. فكما أنك لا ترسل جنديًا إلى المعركة بلا درع وسلاح، فلا يجوز أن تدخل معركة الأفكار الكبرى وأنت أعزل.
كيف تتسلح؟
قبل أن تقرأ لمن “يهدم”، اقرأ لمن “يبني”. تعمّق في فهم عقيدتك الإسلامية بناءً على الأدلة العقلية والنقلية. ادرس براهين وجود الله، وكمال صفاته، والحكمة من أفعاله، ودلائل النبوة. عندما تمتلك تصورًا واضحًا وقويًا عن الحقيقة، تصبح قادرًا على تمييز زيف الشبهة فور رؤيتها، تمامًا كالصائغ الخبير الذي يميز الذهب الحقيقي من المزيف بلمحة بصر.
تعلم “التفكير الناقد”. هذا العلم هو الذي يعطيك القدرة على تفكيك كلام الساحر وكشف خدعته. ستتعلم كيف أن عبارة منمقة قد تخفي مغالطة منطقية سخيفة، وكيف أن سؤالًا عاطفيًا مؤثرًا قد يكون مبنيًا على فرضية خاطئة. حينها، لن تنبهر بجمال العبارة، بل ستبحث عن متانة الحجة خلفها.
الخلاصة: يا صديقي، لا تنخدع ببريق الكلمات. فالأفكار لا تقاس بجمال أسلوبها، بل بمدى صدقها وصمودها أمام النقد والتمحيص.
دعوتنا لك ليست أن تكون جاهلًا بما يقوله الآخرون، بل أن تكون أقوى منهم حجة، وأعمق منهم فكرًا.
ابدأ بكنوزك أولًا. اغترف من بحر اليقين في القرآن والسنة والفكر الإسلامي الرصين. وعندما يشتد عودك وتقوى حجتك، اقرأ لهؤلاء المشككين ليس لتتأثر بهم، بل لتحلل نقدهم، وتكشف ضعف منطقهم، وتزداد يقينًا وقوةً بما أنت عليه. حينها، ستتحول هذه الكتب من مصدر خطر إلى دليل إضافي على قوة الحق الذي تحمله.
السببُ الرابع: سعيُ القنواتِ الفضائيةِ وغيرها من وسائل التّواصلِ والإعلامِ
السببُ الرابع: سعيُ القنواتِ الفضائيةِ وغيرها من وسائل التّواصلِ والإعلامِ لنشرِ مثلِ هذه الافكار، وفتحِ المجالِ لأربابها، وتمكينهم من طرح شُبهاتهم، وتشكيكِ النّاسِ في عقائدهم وأصولِ دينهم، فصاروا كحاملي الأمراضِ المعديةِ يسيرونَ بين اناسٍ غيرَ مُحصنين.
والحل أن نعترف بقوة الإعلام وتأثيره الهائل فنحن لا نواجه أفكارًا متناثرة، بل نواجه “صناعة شك” ممنهجة. الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى مضخات هائلة تعمل على مدار الساعة، لا لتقدم الحقيقة، بل لتبث “فيروسات الشك” في عقول وقلوب الملايين، خاصة أولئك الذين لم يتلقوا “لقاح التحصين الإيماني”.
الأمر أشبه بمن يعيش في مدينة موبوءة، حيث الهواء نفسه ملوث. حتى لو كنت سليمًا، فإن مجرد استنشاقك المستمر لهذا الهواء الملوث سيصيبك بالمرض عاجلاً أم آجلاً.
لماذا هذا السلاح الإعلامي فتاك إلى هذا الحد؟
قوة التكرار: في الإعلام، الكذبة التي تتكرر ألف مرة تبدأ في الظهور كأنها حقيقة. تكرار عرض الشبهة نفسها بأشكال مختلفة (في فيلم، في منشور، في مقابلة) يجعل العقل اللاواعي يألفها، والألفة هي أول خطوة نحو القبول.
صناعة القدوات الوهمية: يتم تقديم الملحد أو المشكك في صورة البطل الذكي، العالم، المفكر الحر، الفنان المبدع. وفي المقابل، يتم تصوير المتدين بصورة رجعية، ساذجة، أو متطرفة. هذه الصورة النمطية تجعل الشاب يربط الإلحاد بـ”الجاذبية والذكاء” والإيمان بـ”التخلف والجمود”.
السيطرة على ساحة النقاش: هم من يضعون الأسئلة، وهم من يختارون الضيوف، وهم من يحررون المحتوى. نادرًا ما ترى نقاشًا عادلًا يتم فيه استضافة عالم مسلم راسخ وقوي الحجة ليرد على الشبهات بنفس القوة والوقت الممنوح للطرف الآخر. إنها معركة غير متكافئة.
كيف نواجه هذا الطوفان؟ الحل ليس في الانعزال، بل في بناء السدود والمناعة
إذا كان الهواء ملوثًا، فالحل ليس أن تتوقف عن التنفس. الحل هو أن ترتدي “كمامة واقية” وتقوي “جهازك المناعي”.
كن أنت حارس بوابة عقلك: عليك أن تدرك أن ما تشاهده وتسمعه يشكّل عقلك وقلبك. لا تكن مستهلكًا سلبيًا لكل ما يُلقى إليك. لديك خيار. كما تختار طعامك بعناية لتحافظ على صحة جسدك، اختر “طعامك الفكري” بعناية أكبر لتحافظ على صحة إيمانك.
نظّف بيئتك الرقمية: ألغِ متابعة الحسابات التي تبث الشكوك والسخرية من الدين. تابع العلماء والدعاة والمفكرين الذين يقدمون محتوى إيجابيًا وعميقًا. الخوارزميات ذكية؛ ما تتفاعل معه يأتيك منه المزيد. اجعل خوارزمياتك تعمل لصالحك، لا ضدك.
وعليك بتقوية الجهاز المناعي الإيماني فالمواجهة الحقيقية ليست بحجب المحتوى الهدام فقط، بل بأن نكون أقوى منه. وهذا يتطلب خطوتين:
التحصين المسبق: لا تنتظر حتى تتعرض للشبهة لتبحث عن الرد. كن مبادرًا. تعلم أساسيات دينك وأدلته القوية. خصص وقتًا يوميًا للقراءة في كتب العقيدة التي كتبت بلغة عصرية، وشاهد البرامج التي ترد على الشبهات بعمق وعقلانية. عندما تمتلك الحقيقة، ستعرف الباطل فور رؤيته.
صناعة البديل الجذاب: يجب أن ننتقل من خانة “رد الفعل” إلى خانة “الفعل”. على المبدعين المسلمين والإعلاميين والمفكرين مسؤولية تاريخية في إنشاء محتوى إسلامي جذاب وقوي ومنافس. نحتاج إلى أفلامنا، ومسلسلاتنا، ووثائقياتنا، وبرامجنا التي تقدم رؤية الإسلام للحياة بجمال وإبداع وعمق، وبلغة يفهمها شباب اليوم وبالضوابط الشرعية.
دعم المحتوى الإيجابي: كل “مشاهدة” و”إعجاب” و”مشاركة” منك لمحتوى إيجابي هي بمثابة صوت انتخابي. أنت تساهم في نشر “الدواء” لمواجهة “المرض”. بدعمك لهذا المحتوى، أنت تخبر المنصات أن هذا ما يريده الناس، فتنتشر الكلمة الطيبة وتحاصر الكلمة الخبيثة.
الخلاصة: نعم، الحرب الإعلامية شرسة، والقصف الفكري عنيف. لكن الخوف والشكوى لا يبنيان حصونًا. كن واعيًا، تحكم فيما يدخل عقلك، ابنِ مناعتك الإيمانية بالعلم والمعرفة، وكن جزءًا فاعلًا في دعم ونشر المحتوى الذي يمثل قيمك.
إنها ليست معركتهم وحدهم، بل هي معركتنا جميعًا للدفاع عن فطرتنا وعقولنا وأجيالنا القادمة.
السببُ الخامس: التبعيةُ والتقليدُ الأعمى، والهزيمةُ النّفسيةُ والانبهارُ بالأقوى
السببُ الخامس: التبعيةُ والتقليدُ الأعمى، والهزيمةُ النّفسيةُ والانبهارُ بالأقوى، فكثيرًا ما تنتشرُ بعضُ الأفكارِ الخاطئةِ خصوصًا بين الشبابِ، لا عن قناعةٍ بها، وإنما تقليدًا لأحد المشاهير، أو تأثرًا بموضةٍ ما.
وهذه النقطة تضرب على وتر حساس جدًا، وهو “أزمة الهوية” والشعور بالدونية. إنه سبب نفسي عميق أكثر منه فكري.
هذه هي الهزيمة التي تسبق كل الهزائم. عندما يُهزم الإنسان من الداخل، يصبح استعماره من الخارج سهلاً. المشكلة هنا ليست في قوة الشبهة، بل في ضعف الروح التي تستقبلها. الشاب لا يتبع هذه الأفكار لأنه اقتنع ببرهانها، بل لأنه انبهر بقائلها، انبهر بالصورة التي تم تصديرها له عن “القوة” و”التقدم” و”النجاح”.
دعنا نحلل هذه الحالة النفسية الخطيرة ونفككها بهدوء:
أولاً: فك شفرة “الانبهار بالأقوى”
ما هو “القوي” الذي ينبهر به الشاب اليوم؟ إنه غالبًا:
المشهور على وسائل التواصل: الذي يعرض حياة من اللامبالاة والرفاهية والمتعة الخالية من أي مسؤولية.
النموذج الغربي: الذي يتم تقديمه كرمز للحرية والتقدم العلمي والتفكير المنطلق.
لكن هذا الانبهار مبني على خدعة بصرية كبرى. نحن لا نرى الصورة كاملة، بل نرى فقط “لقطات” منتقاة بعناية.
نحن نرى ابتسامة المشهور، ولا نرى خلف الكواليس قلقه واكتئابه وفراغه الروحي الذي يعترف به الكثيرون منهم.
نحن نرى التقدم المادي للغرب، ولا نرى معه التفكك الأسري المرعب، ومعدلات الانتحار، وأزمة المعنى التي تجعلهم يستهلكون المهدئات بمعدلات تاريخية.
إنه انبهار بـ “قشرة” براقة تخفي وراءها هشاشة وفراغًا هائلًا. فالذي يتبعهم ليس كمن يتبع القوي، بل كمن يتبع ممثلًا يؤدي دور القوي على المسرح، وينسى أن هذا الممثل سينهار باكيًا في غرفته بمجرد أن يُسدل الستار.
ثانيًا: تشريح “الهزيمة النفسية”
لماذا نشعر بهذه الهزيمة؟ لأننا للأسف، تبنينا مقاييسهم للقوة والنجاح. أصبحنا نقيس أنفسنا بمسطرتهم. وهذا هو الخطأ القاتل.
عندما تقيس نفسك بمعايير خصمك، ستخسر دائمًا.
الإسلام جاء ليمنحك “مسطرتك الخاصة” ومعاييرك الخاصة للقيمة والنجاح.
في ميزانهم: قيمتك في مقدار ما تملك، وما تستهلك، وعدد متابعيك.
في ميزان الإسلام: قيمتك في مقدار ما تحمله من تقوى وعلم وخلق ونفع للناس. ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.
هذه الآية ليست مجرد شعار، إنها إعلان تحرير للإنسان. إنها تقول لك: قيمتك ليست مرتبطة برأي الناس المتقلب، ولا بالموضة العابرة، بل هي مرتبطة مباشرة بمصدر كل القيم، الله عز وجل. هذا يمنحك ثقة وصلابة لا يمكن لأي انبهار خارجي أن يزعزعها.
الخلاصة: اختر أن تكون “الأصل”، لا “النسخة”.
يا صديقي الشاب، الكون كله قائم على التنوع والتفرد. بصمتك فريدة، ونبرة صوتك فريدة، والله خلقك لتكون إضافة مميزة لهذا العالم، لا نسخة مقلدة وباهتة من شخص آخر.
التقليد الأعمى هو أسهل شيء في العالم، إنه لا يتطلب أي مجهود عقلي أو شجاعة نفسية. لكنه يسرق منك أغلى ما تملك: تفردك وهويتك.
الإسلام لا يريدك أن تكون مجرد “صدى” يردد ما يقوله الآخرون. بل يريدك أن تكون “صوتًا” له كلمته ورأيه وحضوره المستقل. التقليد هو عبودية، لأنه يربط قيمتك بغيرك.
أما الإيمان الحقيقي فهو قمة الحرية، لأنه يحررك من كل سلطة إلا سلطة الحق، ومن كل انبهار إلا الانبهار بعظمة الخالق.
الدعوة لك اليوم هي: لا تكن مهزومًا من الداخل فتنكسر أمام أول موجة فكرية عابرة. كن قويًا بإيمانك، معتزًا بهويتك، واثقًا بمنهج ربك. اقرأ تاريخك لترى كيف بنى أجدادك حضارة كانت مصدر النور للعالم كله عندما كانوا “أصلاً” ولم يكونوا “نسخة”.
كن أنت الأصل، ودعهم هم يقلدون قوة تمسكك بمبادئك وثباتك في زمن السيولة.
السببُ السادِس: اعتقادُ البعضِ أنَّ تنحيةَ الغربِ للدّين هو السّببُ الأكبرُ لتقدمِهم
السببُ السادِس: اعتقادُ البعضِ أنَّ تنحيةَ الغربِ للدّين هو السّببُ الأكبرُ لتقدمِهم، فإذا أردنا أن نصلَ إلى ما وصلوا، فلا بدَّ أن نتخلى عن الدّين كما تخلَّوا.
وهذا الكلام خلافُ العقلِ والمنطق، فالعاقلُ يُحسنُ إذا أحسنَ الناس، وإن أساؤوا تجنبَ إساءتهم. وما تقدم الغرب الحالي نتاج الإلحاد والمادية فقد ساهم فيه المسلمون والنصارى واليهود وجميع العقول، والفكرة أن الغرب استثمر في العقول، وفي نفس الوقت يمارس الاحتكار وينهب ثروات الشعوب الأخرى. وما وقع ذلك إلا لضعف وقع علينا وتقصير من حكوماتنا التي لا تعمل لصالح الإسلام والمسلمين بل تحارب الإسلام.
هذا السؤال ليس مجرد شبهة، بل هو سهم موجه إلى قلب ثقة الأمة بنفسها وهويتها. وعندما يرى الشاب الفجوة التكنولوجية الهائلة بيننا وبين الغرب، يبدو له هذا الاستنتاج منطقيًا للوهلة الأولى. لكن العقل المنصف لا يكتفي بالنظر إلى السطح، بل يغوص في الأعماق ليكتشف الحقيقة.
دعونا نفكك هذه المغالطة الكبرى بهدوء وعقلانية، ونطرح ثلاثة أسئلة كاشفة:
السؤال الأول: هل تخلّى الغرب عن “الدين” أم عن “الكنيسة”؟
هنا يكمن مفتاح الخدعة. الغرب لم يقم بثورة ضد “الدين” كمفهوم مطلق، بل قام بثورة ضد تجربة تاريخية محددة مع الكنيسة الأوروبية في العصور الوسطى. تلك الكنيسة التي حاربت العلم والعلماء وأحرقتهم (مثل جوردانو برونو) وحاكمتهم (مثل غاليليو).
وفرضت صكوك الغفران وباعت الجنة بالمال وتحالفت مع الإقطاعيين ضد الشعوب.
كانت ثورتهم ردة فعل طبيعية ومنطقية ضد مؤسسة كانت عائقًا أمام التقدم. والآن، هل هذا الوصف ينطبق على الإسلام؟
بالعكس تمامًا!
الإسلام هو الذي أمر بطلب العلم وجعله فريضة: “اقرأ”، “اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد”.
الإسلام هو الذي انطلقت من مساجده وجامعاته (كالقرويين والأزهر) أعظم حضارة علمية عرفتها البشرية لقرون.
علماء المسلمين (كابن الهيثم، والخوارزمي، والرازي، وابن سينا) هم الذين أسسوا المنهج العلمي التجريبي الذي قامت عليه نهضة الغرب لاحقًا، وهناك من يحاول إلقاء الشبهات حول هذا الأمر بوقوع بعض المشكلات لهؤلاء العلماء.
وهذا بحد ذاته مغالطة سخيفة؛ لأن هؤلاء العلماء شئنا أم أبينا نتاج البيئة والحضارة الإسلامية، ولولا ما توفر لديهم في هذا العصر من إمكانات لما وصلوا إلى هذا العلم، فالتقدم العلمي قرار سياسي وتحرك جماعي وليس نتيجة عمل فردي.
وأما ما يثار حول هؤلاء العلماء فإنه لم يكن بسبب الأمور العلمية والاختراعات، بل بسبب آراء فكرية مخالفة للشريعة الإسلامية، وهذا نقاش يقع في أي مجتمع وفي أي ديانة.
ولذلك فإن الترويج لأكذوبة أن الدول الإسلامية تحارب العلم فهذا أمر مفضوح لا أساس له من الصحة.
إذن، قياس تجربتنا الإسلامية على تجربة أوروبا مع الكنيسة هو قياس فاسد ومغالطة تاريخية صارخة. هم تقدموا عندما تخلصوا من “معوِّق العلم”، ونحن تخلفنا عندما تخلينا عن “محرِّك العلم” وهو روح الإسلام الحقيقية.
السؤال الثاني: ما هو الثمن الحقيقي لـ “التقدم المادي” الغربي؟
لنفترض جدلاً أنهم تقدموا ماديًا بسبب المادية. فهل هذا هو التقدم الوحيد الذي يطمح له أي عاقل؟
إن التقدم الذي لا توازنه قيم وأخلاق هو تقدم أعرج، وغالبًا ما يكون مدمرًا. انظر إلى الثمن الباهظ الذي دفعه الغرب:
انهيار الأسرة: أعلى معدلات الطلاق والتفكك الأسري في التاريخ.
أزمة المعنى: انتشار القلق والعبثية والاكتئاب ومعدلات الانتحار بشكل غير مسبوق.
الجريمة والانحلال: تفشي الجرائم والمخدرات والانحلال الأخلاقي لدرجة تهدد نسيج مجتمعاتهم.
الشذوذ: انتشر الشذوذ في مجتمعاتهم بدرجة مخيفة وظهرت عمليات التحول وعشرات الهويات الجنسية.
الإباحية: لقد أصبح الغرب مركزًا لنشر الفاحشة عبر إنشاء عشرات المواقع الجنسية واستعباد المرأة واستغلالها في عملية قذرة وهي عرض جسدها أو تمثيل الفاحشة، بل أصبحت تعرض علنًا في صناديق بشوارع أوروبا لمن يدفع أكثر، ثم يتحدثون عن حرية وكرامة المرأة في الغرب!
الاستعمار والنهب: جزء كبير من ثروتهم التي بنوا بها نهضتهم كان نتاجًا مباشرًا لنهب ثرواتنا وخيرات شعوب أفريقيا وآسيا على مدى قرون. فهل نسمي هذا “تقدمًا” أم “قرصنة حضارية”؟
الإسلام لا يطلب منا أن نختار بين التقدم المادي والسمو الروحي. بل يقدم لنا نموذجًا متوازنًا فريدًا: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾.
الإسلام يدعونا لـ “عمارة الأرض” وامتلاك أسباب القوة، مع الحفاظ على كرامة الإنسان وقيمه وأسرته. فهل من العقل أن نترك هذا النموذج المتكامل لنتبع نموذجًا أعرج أثبت فشله الأخلاقي والروحي؟
السؤال الثالث: لماذا تخلفنا نحن إذن؟
هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب أن نسأله بصدق وشجاعة.
نحن لم نتخلف لأننا “متمسكون بالإسلام”، بل تخلفنا لأننا “تخلينا عن جوهر الإسلام”. أصبحت بلادنا تحكم بالعلمانية وتتبع طريقًا لا علاقة له بالإسلام، وأكبر دليل على بطلان نسبة التخلف لحكم الإسلام أن المسلمين في عصور التخلف الغربي كانوا في عصر النهضة الذهبية.
كذلك هناك كثير من الدول العلمانية التي تسير في ركاب الغرب وغالبية سكانها من النصارى أو الملاحدة وهي متخلفة والنماذج كثيرة.
فدول الغرب المتقدمة عددها قليل بينما بقية دول العالم ومن ضمنها الدول العلمانية أو النصرانية لم تتقدم مثل الغرب.
مشكلتنا ليست في تطبيق الإسلام بل العكس تمامًا.
مشكلتنا أننا تخلينا عن الأمر الإلهي بتطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل والعدالة الاجتماعية والشورى وطلب العلم والعمل والإتقان: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾.
تخلينا عن الوحدة والقوة التي أمرنا بها: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.
اكتفينا من الدين بطقوسه وشكلياته، وتركنا روحه المحركة التي بنت حضارة ملأت الدنيا عدلاً وعلمًا.
ضعفنا وتقصيرنا، وفساد حكامنا الذين حاربوا الإسلام وشعوبهم، هو الذي فتح الباب للآخرين لينهبوا ثرواتنا ويفرضوا هيمنتهم علينا. المشكلة ليست في الإسلام، بل في المسلمين الذين تخلوا عن أسباب النهضة التي وضعها الإسلام بين أيديهم.
الخلاصة: يا صديقي، المعادلة ليست: (دين = تخلف) و (إلحاد = تقدم).
المعادلة الحقيقية هي: (العلم + العمل + الأخلاق = نهضة حقيقية).
لقد جرب أسلافنا هذه المعادلة في ظل الإسلام فصنعوا حضارة عظيمة. وجربها الغرب مبتورة من الأخلاق، فصنعوا تقدمًا ماديًا مشوهًا يدفعون ثمنه اليوم غاليًا.
الحل ليس أن نتخلى عن ديننا العظيم لنصبح نسخة باهتة منهم، بل الحل هو أن نعود إلى روح ديننا الحقيقية؛ روح العلم والعمل والعدل والقوة. حينها فقط، سنقدم للعالم نموذج النهضة المتوازنة الذي ينتظره.
السببُ السابع: كثرةُ الحروبِ والفتنِ، وانتشارُ الظّلمِ
السببُ السابع: كثرةُ الحروبِ والفتنِ، وانتشارُ الظّلمِ وعدمُ قُدرةِ الضّعفاءِ على الوصول إلى حقوقهم، مما قد يهزُ قناعاتِ البعضِ منهم في العدل وفي عقيدة القضاءِ والقدر. فيجدُ نفسهُ يتساءل: لم أنا بالذات؟.. ولماذا يسمحُ الله بهذا؟.. فإذا لم يجد من يُجيبُه بمنطقٍ سليمٍ، وأسلوبٍ مقنع.. وإلا تحولت هذه التساؤلات إلى بوابةٍ للشك والإلحاد.
“لماذا يسمح الله بهذا؟”.. هذا ليس سؤالاً، بل صرخة. صرخة طفل يرى أمه تُقتل، وصرخة مظلوم لا يجد من ينصره، وصرخة ضعيف يسحقه الظلم. ومن لا يتألم لهذا المشهد فهو ليس بإنسان. والإسلام لا يطلب منك ألا تتألم، بل يعطيك معنى لهذا الألم، ويمنحك اليقين في نهايته.
دعنا نواجه هذا السؤال المدمر بشجاعة وعقلانية، ونفككه إلى ثلاثة أجزاء حاسمة:
الجزء الأول: خطأ في فهم “وظيفة الدنيا”
الكثير من ألمنا يأتي من أننا نطلب من الدنيا شيئًا لم تُخلق له. نحن نتعامل مع هذه الحياة كأنها “الجنة”، وننتظر فيها العدل المطلق والراحة الكاملة. وعندما نصطدم بحقيقتها المرة، نصاب بخيبة أمل ونتهم الله عز وجل.
ولكن الله تعالى لم يعدنا بهذا قط. القرآن واضح جدًا في تعريف وظيفة هذه الحياة: إنها “قاعة اختبار”، وليست “صالة احتفالات”.
قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾.
وقال: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾.
باختصار: الله لم يعدك بالجنة في الدنيا بل في الآخرة.
تخيل لو أن أستاذًا وزّع ورقة الامتحان على طلابه، ثم قام بإعطاء الجميع الدرجة النهائية في أول دقيقة! هل هذا عدل؟ بالطبع لا، هذا هو قمة العبث والظلم، لأنه يساوي بين من درس واجتهد ومن أهمل ولعب.
الدنيا هي ورقة الامتحان. وجود الظالم والمظلوم، والصابر والشاكي، والمجاهد والقاعد، هو جزء من طبيعة هذا الاختبار. فلو لم يوجد الظلم، كيف كان سيظهر “العدل” كقيمة عليا يُجاهد من أجلها؟ ولو لم يوجد الألم، كيف كان سيظهر “الصبر الجميل” كأرقى مقامات الإيمان؟
العدل الإلهي الكامل والمطلق له مكانه المخصص: يوم القيامة. يوم تُنصب الموازين، ويقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أما الدنيا، فهي ساحة ظهور الأفعال ليترتب عليها الجزاء.
الجزء الثاني: ما هي حكمة الألم والظلم؟
لماذا يسمح الله بهذا الاختبار القاسي؟ لأن وراءه حكمًا بالغة قد لا ندركها بعقولنا المحدودة، لكن الإيمان يرشدنا إليها:
التمييز والتمحيص: الابتلاءات هي التي تكشف معادن الناس الحقيقية. في أوقات الرخاء، الكل يدّعي الإيمان. لكن في أوقات الشدة، يظهر الصادق من الكاذب.
التذكير والتطهير: الألم يوقظنا من غفلتنا، يكسر كبرياءنا، ويذكرنا بضعفنا وحاجتنا المطلقة إلى الله. كم من إنسان لم يعرف طريق المسجد إلا بعد مصيبة؟ وكم من ذنب ومعصية يمحوها الله بدمعة ألم وصبر؟
رفع الدرجات: أعظم الناس أجرًا هم أعظمهم بلاءً. الأنبياء، وهم أحب الخلق إلى الله، كانوا أشدهم ابتلاءً. فالبلاء في حق المؤمن ليس عقابًا دائمًا، بل هو غالبًا ترقية في درجات الجنة لا يمكن الوصول إليها بمجرد العمل.
الجزء الثالث: ماذا يقدم الإلحاد كحل بديل؟
وهنا نصل إلى السؤال الأهم. لنفترض أننا غضبنا من هذا الواقع، وقررنا أن نلحد. فماذا قدم لنا الإلحاد كحل؟
الإلحاد لا يقدم أي حل على الإطلاق. بل يجعل المأساة أسوأ وأشد قتامة.
في ظل الإيمان: ألمك له معنى، وصبرك له جزاء، والظالم سينال عقابه، وحقك لن يضيع. هناك أمل في عدالة نهائية ومطلقة. هناك رب حكيم وعدل تلجأ إليه.
في ظل الإلحاد: ألمك عبثي، وموتك نهاية، والظالم قد أفلت بفعلته إلى الأبد، وحقك قد ضاع بلا عودة، وتساوى القاتل مع المقتول والظالم مع المظلوم تحت التراب. لا معنى لهذا الكون، ولا حكمة، ولا عدالة، لا أمل. مجرد صراع دموي في غابة كونية صماء، ينتهي بالعدم! هل هذا منطقي؟!
أي النظرتين أكثر منطقية وعقلانية؟ وأيهما تمنح الإنسان القوة لمواجهة مصاعب الحياة؟ هل هي النظرة التي تعطي للألم معنى وأملاً، أم تلك التي تجرده من كل شيء وتتركه مجرد معاناة عشوائية بلا هدف؟
الخلاصة: يا صديقي المتألم، صرختك مسموعة، ودمعتك يراها الله.
لا تجعل ألمك من ظلم البشر يقودك إلى ظلم نفسك بالشك في عدل الله. فالله ليس هو الظالم – تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا – بل الظلم من صنع البشر الذين اختاروا بسوء إرادتهم أن يرسبوا في الاختبار.
ثق أن كل دمعة ألم، وكل ليلة سهر، وكل حق ضائع، مسجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأن ميزان العدل الإلهي قادم لا محالة، وسيكون دقيقًا لدرجة أن المظلوم سيفرح بأنه ظُلم ليأخذ من حسنات ظالمه في يوم هو أحوج ما يكون إليها. ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾. هذا هو وعد الله، ووعده الحق.
السببُ الثامن: مُعاناةُ البعضِ من الاضطرابات النّفسيةِ والعصبية
السببُ الثامن: مُعاناةُ البعضِ من الاضطرابات النّفسيةِ والعصبية؛ نتيجةَ تعرضِهم لظروفٍ أُسريةٍ واجتماعيةٍ قاسيةٍ ومعقدة، مما يُفقدهم القُدرَةَ على التّفكير الصّحيح، وجعلهم يظنون أنّ ما يُعانونه من آلامٍ دليلُ غيابِ الإلهِ الحكيم، فيقعون في الإلحاد لا عن قناعةٍ عقلية، وإنما هروبًا من الألم، أو تعبيرًا عن الغضب، كما قال بعضهم: “أنا لا أكرهُ الله، أنا فقط غاضبٌ منه”.
بالتأكيد. هذه هي المنطقة الأكثر حساسية وألمًا، حيث لا تكون القضية فكرية بقدر ما هي روحية ونفسية. هنا، الحجة العقلية وحدها لا تكفي، بل لا بد من لمسة حانية تضمد الجرح قبل أن تخاطب العقل.
هذه الجملة: “أنا لا أكره الله، أنا فقط غاضب منه”.. ليست شبهة فكرية بحد ذاتها، بل من الواضح هي نزيف روحي يشعر به الإنسان بسبب الضغوط الهائلة وربما العجز عن التصرف أو اليأس وغيرها من الأسباب.
وهنا، يجب أن نتوقف عن الكلام كفلاسفة، ونبدأ بالإنصات كأطباء للقلوب.
الشخص الذي يصل إلى هذه النقطة لا يحتاج إلى براهين فلسفية معقدة، فهو لا يعاني من فراغ في عقله، بل من جرح غائر في روحه. ألمه حقيقي، وصدمته حقيقية، وشعوره بالخذلان قد طغى على كل شيء.
دعنا نتحدث بصراحة ودفء مع هذا القلب المجروح:
قبل أي شيء آخر، اعلم أن الله يرى ألمك ويعرف قسوة الظروف التي مررت بها.
هو أقرب إليك من حبل الوريد، ويسمع أنين روحك حتى لو لم تتكلم.
هذا الشعور ليس دليلاً على أنك شخص سيئ، بل هو دليل على عمق الجرح الذي تحمله. إنه ردة فعل إنسانية طبيعية على ألم يفوق التحمل لكنها للأسف خاطئة في سوء التعبير وتوجيه الغضب وسوء الظن بالله عز وجل.
ربما تعرض هذا الشخص لظلم شديد أو معاملة قاسية أو أنانية تسببت في كسره وغيرها من الجروح التي تكون عادة إنسان أساء إليه أو مجتمع خذله أو قصر في حقه قرب أو كسروا شيئًا جميلًا في داخله. فهل من العدل والمنطق أن نوجه غضبنا نحو “صانع” هذا الشيء الجميل، بدلًا من توجيهه نحو من “كسره”؟
أجمل ما في الإسلام أنه لا يطلب منك أن تكبت مشاعرك. انظر إلى نبي الله يعقوب عليه السلام، عندما فقد ابنيه، يوسف ثم بنيامين. هل كفر أو غضب؟ لا. بل قال قولاً يذيب القلوب: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.
هو لم يشتكِ “من” الله، بل اشتكى “إلى” الله! هذا هو مفتاح الشفاء. الله لا يريدك أن تتظاهر بالقوة أمامه. يريدك أن تأتي إليه بكل ضعفك، وانكسارك، وألمك. الجأ إليه، وابكِ بين يديه، وقل له كل ما في قلبك: “يا رب، أنا موجوع. يا رب، أنا متألم.”
هذه الشكوى ليست اعتراضًا على قدره، بل هي “دعاء” واعتراف بأنه الوحيد القادر على جبر كسرك وشفاء جرحك.
ثالثًا: تعرف على اسم الله “الجبّار”
من أجمل أسماء الله الحسنى اسم “الجبّار”. والكثيرون يظنون أن معناه فقط القوي القهار. لكن من معانيه العظيمة أنه “الذي يجبر كسر عباده”. هو طبيب القلوب المنكسرة، وبلسم الأرواح المتألمة. أنت تفرّ من الطبيب الوحيد الذي يملك دواءك. تصرخ من ألم الكسر، وتهرب ممن يريد أن “يجبره” لك. إن الإلحاد لن يشفي جرحك، بل سيضع عليه ملحًا؛ سيخبرك أن ألمك بلا معنى، وأن معاناتك عبثية، وأنه لا يوجد أمل في شفاء أو عدل. إنه يتركك وحيدًا في كون بارد وموحش مع جرحك المفتوح.
أما الإيمان فيقول لك: “ألمك له حكمة، وصبرك له أجر، وجرحك سيجبره الله، وحقك سيعود إليك كاملاً في يوم العدل الأعظم”.
وهناك ألم آخر ينبغي ألا نهمله وهو الابتلاء الذي يتعرض له المرء من الله عز وجل مما يجعل بعض الأشخاص يتسخطون ويعترضون على قدر الله عز وجل.
أصيب أحدهم بمرض عضالف، أو إعاقة ولد بها، أو مصيبة أخرى؟ وهنا السؤال يصبح أعمق وأثقل: “لماذا اختارني الله لهذا البلاء؟”
هنا بالذات، يقدم الإسلام رؤية تحويلية ترفع الألم من كونه نقمة عبثية إلى كونه “اصطفاءً لحكمة”.
البلاء ليس دائمًا عقوبة: في حق المؤمن، غالبًا ما يكون البلاء علامة محبة لا علامة غضب.
هو تربيةٌ إلهية، وصقلٌ للروح، ورفعٌ في الدرجات. كل دمعةٍ تصبر عليها، وكل لحظةِ وجعٍ تحتسبها، تُكتب لك نورًا يوم القيامة. المرض يُضعف الجسد، لكنه يُطهّر القلب. والإعاقة تُقيد الحركة، لكنها تُحرر الروح من التعلق بزينة الدنيا.
فلا تجعل مرضك أو عجزك سببًا في البعد عن الله، بل اجعله طريقًا إلى القرب منه. هو الذي ابتلاك ليطهّرك، لا ليعذبك؛ ليُريك ضعفك بين يديه، لا ليكسرك. والدواء ما زال هو نفسه: لا تهرب منه، بل اهرب إليه، فهو وحده الذي يملك أن يجبر قلبك وبدنك وروحك جميعًا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن عِظم الجزاء مع عِظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم”. الابتلاء الشديد هو للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
انظر إلى نبي الله أيوب، الذي أصبح رمز الصبر في تاريخ البشرية كلها، هل كان بلاؤه علامة على غضب الله أم على مكانته العظيمة عنده؟
طريق مختصر لرفع الدرجات: أحيانًا تكون لك منزلة عالية في الجنة، لا تبلغها بمجرد صلاتك وصيامك، فيبتليك الله بما تكره ليرفعك إليها بصبرك. ألمك اليوم هو استثمار في بيتك غدًا في الجنة.
تطهير وتكفير: ما من شوكة تصيب المؤمن إلا كفّر الله بها عن خطاياه. هذا الألم الذي تشعر به الآن قد يكون هو الثمن الذي يمحو الله به ذنوبًا كنت ستلقاه بها يوم القيامة.
هذا الفهم لا يزيل الألم الجسدي، لكنه يزرع في القلب معنى وغاية ورجاء، وهذا هو الفارق الجوهري بين رؤية المؤمن ورؤية الملحد الذي يرى ألمه مجرد عذاب عشوائي في كون قاسٍ وأصم.
“ألمك له حكمة، وصبرك له أجر، وجرحك سيجبره الله إما بشفاء في الدنيا، أو بجزاء عظيم في الآخرة يجعل أهل العافية يتمنون لو قُرضوا بالمقاريض لما يرون من عظيم الثواب”.
الخلاصة: يا صديقي الذي أنهكه الألم، لا تدع قسوة البشر تجعلك تسيء الظن برب البشر. لا تهرب منه، بل اهرب إليه. حوّل صرخة الغضب الموجهة للخارج، إلى مناجاة ودعاء وبكاء على عتبته. تمامًا كالطفل الذي إذا ضربه شخص في الشارع، لا يهرب إلى الشارع، بل يركض باكيًا إلى حضن أمه، لأنه يعلم أن الأمان والشفاء هناك. باب الله مفتوح لك. هو ينتظرك ليسمعك، ويواسيك، ويجبر كسرك، ويملأ روحك بالسكينة التي فقدتها. فلا تبحث عن الدواء في مكان الداء. الدواء كله عنده سبحانه.
السببُ التاسع: الصحبةُ السّيئة
السببُ التاسع: الصحبةُ السّيئة، فالصّاحبُ ساحِب، والمرءُ على دين خليله، وعن المرءِ لا تسأل وسل عن قرينه… فكلُّ قرينٍ بالمقارن يقتدي.
هذا السبب ليس مجرد عامل مساعد، بل هو غالبًا البيئة الحاضنة التي تنمو فيها كل الأسباب الأخرى. إنه القانون الاجتماعي والروحي الذي لا يتخلف: “عدوى الأرواح”. أنت نتاج متوسط الأشخاص الخمسة الذين تقضي معهم معظم وقتك. فالأفكار والقناعات تنتقل بين الأصحاب بالعدوى، تمامًا كالفيروسات، لكنها عدوى خفية لا ترى بالعين، تصيب الروح والقلب أولاً، ثم العقل واللسان.
دعنا نحلل كيف تتم هذه “العدوى” بصمت، وكيف تحول شخصًا سليم الفطرة إلى إنسان متشكك حائر.
كيف تعمل “العدوى” على ثلاث مراحل؟
مرحلة التهوين والتطبيع: في البداية، عندما يجلس الشاب مع صحبة تتجرأ على الثوابت الدينية، أو تسخر من الشعائر، أو تطرح الشبهات كنوع من “التحرر الفكري”، يشعر بالصدمة والنفور. لكن مع تكرار الأمر يومًا بعد يوم، يبدأ “جهاز الإنذار الفطري” لديه بالتعطل. ما كان منكرًا كبيرًا، يصبح أمرًا “عاديًا”. وما كان صادمًا، يصبح مجرد “وجهة نظر أخرى”. هنا، يتم تآكل الحصون الداخلية للشاب ببطء ولكن بثبات.
مرحلة التبنّي الجزئي: بعد أن أصبحت الشبهات والسخرية جزءًا من “لغة المجلس” اليومية، يبدأ الشاب، تحت ضغط الرغبة في الانتماء للمجموعة وعدم الظهور بمظهر “المتخلف” أو “الرجعي”، في تبني بعض هذه الأفكار. قد يبدأ بترديد بعض الشبهات على سبيل الفضول، أو استخدام بعض مصطلحاتهم ليثبت أنه “منفتح العقل”. هو لا يدرك أنه في هذه المرحلة، لم يعد مجرد مستمع، بل أصبح “حاملاً للفيروس”.
مرحلة الدفاع عن الفكرة: هذه هي المرحلة النهائية والأخطر. بعد أن تشبّع قلبه وعقله بهذه الأفكار، وبعد أن أصبحت جزءًا من هويته الجديدة داخل المجموعة، يبدأ في الدفاع عنها بشراسة. لم يعد الأمر مجرد شكوك عابرة، بل أصبحت “قناعات” يجادل من أجلها، ليس بالضرورة لأنه وصل إليها ببحث وبرهان، بل لأن الطعن فيها أصبح طعنًا في هويته واختياره وصحبته. لقد تحول من ضحية للعدوى إلى ناشر لها.
الوصفة النبوية: تشخيص وعلاج في حديث واحد
لقد لخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الكونية كلها في مثال عبقري واحد، هو ليس مجرد حديث، بل هو “أداة تشخيص” لعلاقاتك: “مَثَلُ الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك: إما أن يُحذيك (يعطيك)، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة. ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة”.
تأمل في هذا التشريح الدقيق:
الجليس الصالح (حامل المسك): كل الاحتمالات معه ربح. أفضلها أن “يُحذيك”، أي يعطيك من علمه وإيمانه هدية. وأوسطها أن “تبتاع منه”، أي تتأثر بأخلاقه فتكتسبها. وأقلها، حتى لو لم تفعل شيئًا، أن “تجد منه ريحًا طيبة”، أي تشعر بالسكينة في مجلسه وتُعرف به فتتحسن سمعتك.
جليس السوء (نافخ الكير): كل الاحتمالات معه خسارة. أسوأها أن “يحرق ثيابك”، أي يوقعك في الشبهات أو المعاصي مباشرة. وأقلها، حتى لو كنت قويًا وصامدًا، أن “تجد منه ريحًا خبيثة”، أي يتلوث قلبك بسماع المنكر، وتتأذى روحك، وتسوء سمعتك بمجرد الجلوس معه.
“لكنني قوي، وأريد أن أؤثر فيهم!”
قد يقول قائل: “أنا واثق من نفسي، ولن أتأثر بهم، بل سأجلس معهم لهدايتهم”. هذه نية طيبة، لكنها قد تكون فخًا من الشيطان. فالطبيب الذي يعالج مريضًا بمرض شديد العدوى، يدخل عليه وهو يرتدي أقصى درجات الوقاية. فهل أنت محصّن علميًا وإيمانيًا لدرجة أن تجلس في بيئة موبوءة دون أن تتأثر؟
القاعدة هي: لا تُصلح الآخرين على حساب إفساد نفسك. أثّر فيهم من الخارج، كن أنت “حامل المسك” الذي يبحثون عنه، لكن لا تدخل إلى “الكير” لتحاول إطفاءه بيدين عاريتين فيحرقك.
الخلاصة: يا صديقي، قضية اختيار الأصحاب ليست قضية ثانوية أو اجتماعية بحتة، إنها في صميم دينك ومصيرك. إنها اختيار للهوية التي تريدها لنفسك. قبل أن تجلس في مجلس، اسأل نفسك: هل هذا المجلس يزيد من قربي لله أم يبعدني عنه؟ هل أخرج منه بقلب أصفى أم أشد قسوة؟ هل رائحته “مسك” أم “كير”؟
انظر جيدًا في وجوه من تجالسهم اليوم، ففي ملامح أفكارهم وأخلاقهم، سترى نسخة مستقبلية من نفسك. فاختر لنفسك المستقبل الذي يرضي ربك، ويسعدك في دنياك وآخرتك.
السببُ العاشر: عدمُ مواكبةِ الكثيرِ من المشايخ والعُلماءِ للمستجدات المتسارعة
السببُ العاشر: عدمُ مواكبةِ الكثيرِ من المشايخ والعُلماءِ للمستجدات المتسارعة، والتّأخرُ في الردّ على الشّبهات، وتركِ الشّبابِ فريسةً لها، خصوصًا مع إحجامِ الكثيرِ من الشّباب عن مُناقشةِ هذه الأفكار؛ خوفًا من أن يتعرضَ للإحراج أو التّصنيفِ أو العقوبة.
هذا السبب هو “العامل الداخلي” الذي يفاقم كل الأسباب الخارجية. عندما تضعف القلعة من الداخل، يصبح اقتحامها من الخارج سهلاً. هذا السبب لا يتعلق بالشباب بقدر ما يتعلق بالقيادة الفكرية والدينية التي من المفترض أن تكون خط الدفاع الأول عنهم.
هذا ليس مجرد سبب، بل هو اعتراف مؤلم بوجود “فراغ قيادي” في معركة الأفكار اليوم. الشاب اليوم لا يعيش في جزيرة منعزلة، بل في محيط هائج من الشبهات التي تُقذف عليه من كل اتجاه وبكل لغات العصر (علمية، فلسفية، فنية). وعندما يلتفت ليبحث عن سفينة نجاة أو طوق إنقاذ لدى بعض من يمثلون الدين، يجده أحيانًا إما غائبًا، أو بطيئًا، أو يتحدث بلغة لا يفهمها، أو الأسوأ من ذلك، ينهره على مجرد طرح السؤال.
هذه الفجوة لا تُقاس بالمسافات، بل بالزمن، وباللغة، وبالثقة المفقودة. دعنا نحللها بعمق:
أولاً: فجوة الزمن والسرعة
هم: الشبهة اليوم تُصنَع في مختبرات فكرية، وتُغلَّف في مقطع فيديو جذاب مدته ثلاث دقائق، وتنتشر لتصل إلى ملايين العقول في ساعات.
نحن (في بعض الأحيان): الرد يأتي بعد أسابيع أو شهور، في محاضرة طويلة أو كتاب متخصص، بعد أن يكون “فيروس الشك” قد استقر وتمكن من عقل الشاب وقلبه.
نحن نخوض معركة سريعة بأدوات بطيئة. وهذا تأخير استراتيجي قاتل. ففي عالم الأفكار، من يصل أولاً، غالبًا ما يربح الجولة الأولى.
ثانيًا: فجوة اللغة والخطاب
المشكلة ليست في لغة الضاد، بل في “لغة العصر”. الشاب اليوم يفكر بمنطق مختلف، ويطرح أسئلة مستوحاة من الفيزياء الكمية، ونظرية التطور، والفلسفة الوجودية، ومسلسلات نيتفليكس.
هو يسأل والرد التقليدي أحيانًا يكون: “هذه وسوسة من الشيطان، استعذ بالله واشتغل بما ينفعك”.
هذا الرد هو الأصل لكل مسلم، وهو ما يجب أن يكون عليه كل المسلم المتمسك بإيمانه وأهل اليقين، لكنه بالنسبة للشاب الذي تمكنت الشبهة من قلبه وعقله بمثابة إغلاق الباب في وجهه، فالسائل الحائر يحتاج إلى أجوبة مقنعة على أسئلته التي تؤرقه.
فماذا تكون النتيجة؟ يتعلم الشاب درسًا قاسيًا: “أسئلتي ليست موضع ترحيب هنا أو ليس عليها أجوبة”.
فيذهب بها إلى حيث يجد الترحيب: منتديات الملحدين ومواقع المشككين الذين يفتحون له أذرعهم، ويقولون له: “رائع أنك تفكر! تعال، نحن نقدر أسئلتك”، فيقدمون له سمهم في عسل من الترحيب والاحتواء.
قال الإمام المازري رحمه الله في تعليقه على حديث: (يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته).
ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها، قال: والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر فى دليل إذ لا أصل له ينظر فيه، وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها والله أعلم.
إذن، ما هو الحل؟ بناء الجسور فوق الفجوة
الحل ليس في جلد الذات، بل في العمل المنهجي لسد هذه الفجوات:
صناعة “العلماء المتخصصين”: نحن بحاجة ماسة إلى جيل جديد من الدعاة والمفكرين والعلماء الذين هم “قوات خاصة” فكرية. هؤلاء ليسوا فقط فقهاء أو محدثين، بل هم متعمقون في الرد على الشبهات، وقادرون على تفكيكها من جذورها وبناء اليقين على أسس عقلانية وإيمانية صلبة.
تحديث الأدوات والمنصات: يجب أن ننتقل من “الدفاع” إلى “المبادرة”. صناعة محتوى جذاب، وسريع، وعميق بلغة العصر عبر المنصات التي يتواجد فيها الشباب. بودكاست، مقاطع قصيرة، مناظرات راقية، أفلام وثائقية… يجب أن نزاحمهم في ملعبهم وبأدواتهم.
إنشاء “المساحات الآمنة” للحوار: وهذا هو الأهم. يجب على كل مسجد، وكل مركز إسلامي، وكل أب وأم، أن يوفروا مساحة آمنة يستطيع فيها الشاب أن يطرح “أغبى” سؤال و”أخطر” سؤال دون أن يشعر بالخوف أو الخجل. يجب أن نكرم السائل لاحترامه لعقله، ونحتويه لنصل معه إلى اليقين.
الخلاصة: المسؤولية مشتركة. على الشباب ألا ييأسوا من أول تجربة سيئة، وأن يبحثوا بجد عن أهل العلم الحقيقيين المنفتحين. وعلى العلماء والدعاة والمؤسسات الدينية مسؤولية تاريخية في تطوير خطابهم، وتسريع استجابتهم، وفتح قلوبهم قبل عقولهم لأسئلة الجيل الحائرة.
إن لم نبنِ هذه الجسور اليوم، فإننا نخاطر بفقدان جيل كامل سيذهب ليبحث عن أجوبته لدى من لا يريدون له إلا الضياع.
الخاتمة وخارطة الطريق
وبعد هذه الرحلة في أعماق الأسباب، واستعراض هذه الدوافع التي تدفع بعض شبابنا نحو شاطئ الإلحاد الموحش، نصل إلى حقيقة كبرى وواضحة: إن الإلحاد في جوهره ليس انتصارًا للعقل كما يُصوَّر له، بل هو في كثير من الأحيان صرخة مكتومة؛ صرخة فراغ لم يجد من يملؤه باليقين، أو جرح لم يجد من يضمده بالرحمة، أو شهوة لم تجد من يهذبها بالحكمة، أو هزيمة نفسية أمام بريق خادع.
لقد رأينا كيف أن الشكوك غالبًا لا تولد من قوة البرهان، بل من ضعف الحصن، وكيف أن وهم “الحرية” يقود إلى عبودية أشد قسوة، وكيف أن الألم والظلم، بدلًا من أن يكونا جسرًا لمعرفة الله الصبور العدل، يصبحان حجة للغضب منه والفرار.
واليوم، يقف الشاب الحائر أمام مفترق طريقين لا ثالث لهما:
طريق يقدم له عالمًا باردًا قام على الصدفة العمياء، وحياة بلا غاية إلا متعة عابرة، وألمًا بلا معنى، وظلمًا بلا قصاص، ومصيرًا ينتهي إلى العدم والتراب. طريق يقتل كل الأسئلة الكبرى بجواب واحد يائس: “لا شيء”.
وطريق يقدم له كونًا بديعًا له خالق حكيم عليم، وحياة لها هدف وغاية هي عبادته وعمارة الأرض، ومعنى لكل ألم وابتلاء، ووعدًا بالعدل المطلق الذي لن يضيع فيه مثقال ذرة، ومصيرًا أبديًا إما في نعيم مقيم أو عذاب أليم. طريق يجيب على كل الأسئلة الكبرى بيقين يملأ القلب سكينة والعقل قناعة.
إنها دعوة صادقة لكل شاب وفتاة: لا تجعلوا ردود أفعالكم على ضعف بعض المتدينين، أو على ظلم بعض البشر، أو على بريق الإعلام الخادع، هي التي تحدد مصيركم الأبدي. لا تطفئوا نور الفطرة في قلوبكم، ولا تعطلوا عقولكم عن التفكير العميق والمجرد.
ابحثوا عن الحقيقة بصدق، لا بحث من يريد أن يثبت شكوكه، بل بحث من يريد أن يصل إلى اليقين. وفي خضم هذا البحر المتلاطم من الأفكار، سيظل الإيمان بالله هو المرساة الوحيدة التي تمنح سفينة الحياة استقرارها، والبوصلة التي توجهها بأمان إلى شاطئ الطمأنينة واليقين. ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾.
خارطة طريق طالب اليقين (مكتبة مقترحة)
ولأن هذا الطريق إلى اليقين يحتاج إلى زادٍ من العلم ونورٍ من المعرفة، فإننا نختم هذه الرحلة بخارطة طريق لأهم ما كُتب في هذا الباب، مكتبة متكاملة وضعها مفكرون وعلماء، لتكون عونًا لكل باحث عن الحقيقة. وقد قسّمناها إلى أبواب لتسهيل رحلتك، فاختر منها ما يناسب نقطة البداية التي تقف عندها:
حوار مع صديقي الملحد – د. مصطفى محمود
الإلحاد للمبتدئين – د. هيثم طلعت
لأنك الله – علي بن جابر الفيفي
في أدلة وجود الخالق والعقيدة والتفكير النقدي:
براهين وجود الله في النفس والعقل والكون – د. سامي عامري
خرافة الإلحاد – د. عمرو شريف
المخرج الوحيد – عبد الله الشهري
رحلة عقل – د. عمرو شريف
قصة الإيمان – الشيخ نديم الجسر
الفيزياء ووجود الخالق – د. جعفر شيخ إدريس
كامل الصورة– أحمد السيد
العلموية في الميزان – د. سامي عامري
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين – أبو الحسن الندوي
الإسلام يتحدى – وحيد الدين خان
الإنسان ذلك المجهول – أليكسيس كاريل (ترجمات إسلامية معتمدة)
في تفكيك الإلحاد الجديد والشبهات المعاصرة (د. سامي عامري نموذجًا):
الإلحاد يهزم نفسه – د. سامي عامري
ميليشيا الإلحاد: مدخل لفهم الإلحاد الجديد – د. عبد الله العجيري
شموع النهار – د. عبد الله العجيري
الإلحاد في مواجهة نفسه – د. سامي عامري
كواشف زيوف – د. عبد الرحمن حبنكة الميداني
مشكلة الشر ووجود الله: الرد على أبرز شبهات الملاحدة – د. سامي عامري
شبهة فمن خلق الله؟ – د. سامي عامري
لماذا يطلب الله من البشر عبادته؟ – د. سامي عامري
براهين النبوة – د. سامي عامري
الحداثيون العرب والعدوان على السنة النبوية – د. سامي عامري
ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث – د. سلطان العميري
الإسلام بين الشرق والغرب – علي عزت بيجوفيتش
في العلم والفلسفة الغربية (تفنيد الإلحاد العلمي):
الله يتجلى في عصر العلم – مجموعة من العلماء الأمريكيين
تصميم الحياة – ويليام ديمبسكي ومايكل بيهي
صندوق داروين الأسود – مايكل بيهي
توقيع في الخلية – ستيفن ماير
وهم الشيطان: الإلحاد وإخفاقاته العلمية – ديفيد بيرلنسكي
هناك إله: كيف غير أشهر ملاحدة العالم رأيه – أنتوني فلو
الحقيقة الإلهية: البرهنة على وجود الله – حمزة أندرياس تزورتزس
مقبرة الإله: هل طوى العلم على الإيمان؟ – جون لينوكس
قضية الخالق – لي ستروبل
لغة الإله – فرانسيس كولينز
عودة فرضية الإله – ستيفن ماير
إن هذه القائمة ليست مجرد أسماء كتب، بل هي مفاتيح لأبواب من النور، وأسلحة فكرية في معركة الوعي. فلتكن رحلتك في طلب اليقين رحلة علم وبرهان، لا رحلة شك وهذيان. وليكن شعارك دائمًا قول الحق سبحانه: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾.
بقلم: مصطفى الشرقاوي